ليس للذاكرة من درب للغياب.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|

د. تاليا عراوي – بيروت
“دايمًا بالآخر في آخر.. في وقت فراق و بعد الفراق، لقاء”
كلمات أخيرة كتبتها على دفتر العزاء والست فيروز في ردائها الأسود وسط صمتها الصارخ.
أشعر وكأن العالم الخارجي بات فيلماً أمريكياً طويلاً، يعرض بلا توقف، حلقة لا تنتهي من الدراما والتشتيت. وبينما تدور البكرات بلا هوادة أو كلل، يظل الكثيرون حولنا فريسةً لسباتهم العقائدي العميق، غافلين تماماً عن أصداء زمنٍ عرّفنا وكونّنا.

أما نحن؟ فقد نشأنا على أسماء لم تكن مجرد أصوات؛ بل كانت ركائز هويتنا الراسخة: حاوي. الرحباني. مارسيل خليفة. لم يكونوا مجرد فنانين أو مفكرين؛ بل كانوا معماريي أرواحنا، ورواة قصص وجودنا الجماعي. أصواتهم، ألحانهم، كلماتهم – شكلت المخطط الأساسي لما كنا عليه، نسيجاً غنياً نابضاً بالحكمة، البصيرة العميقة، والحب الشديد الذي لا يتزعزع لهذه الأرض المعقدة.
كلنا كنا نُدندن أبيات خليل حاوي فباتت كلماته نشيدنا الهادئ الذي يحمله الهواء:
يَعبرونَ الجِسرَ في الصبحِ خفافًا
أَضلُعي امتَدَّتْ لَهُم جِسْرًا وطيدْ
مِن كُهوفِ الشرقِ, مِن مُستنْقعِ الشَرقِ
إِلى الشَّرقِ الجديدْ
أَضْلُعي امْتَدَّتْ لَهُم جِسْرًا وطيدْ

لم يكن هذا مجرد شعر بالنسبة لنا؛ بل كان صرخة حشد، رؤيا لتجديد متجذرة بعمق في وعينا الجماعي.
تربينا على المُثل النارية لـ القومية، مؤمنين بكل ذرة في كياننا بحلم أمة عربية واحدة، بقوة الوحدة الكامنة، بعدالة فلسطين التي لا تتزعزع، وبضرورة قصوى هي الوقوف إلى جانب الفقراء. لم تكن هذه مجرد أفكار مجردة؛ بل كانت الهواء الذي نتنفسه، والمبادئ التي شكلت نظرتنا للعالم. أما زياد الرحباني؟ آه يا زياد! لقد تحدث مباشرة إلى قلوبنا، عقولنا، وإيديولوجياتنا الأعمق ببراعة لا مثيل لها. كشف التناقضات، الآمال الرقيقة، والحقائق المريرة لوجودنا الجماعي، فجعلنا نضحك حتى الألم ونبكي حتى الانهيار، غالباً في نفس الوقت. لقد كنت، حقاً، صوتنا الجماعي، تعبيرنا الخام والصادق.

لا أزال أتخيلهم بوضوح، نابضين بالحياة في مخيلتي (مع حفظ الألقاب الملخصة “طنط “): ديزي الأمير، أول صديقات أمي، بشعرها الأحمر الناري الذي لا يُنسى ولهجتها العراقية المميزة المحببة. و أدما حمادة، المرأة التي كانت تمتلك صوتاً عالياً وقوة هائلة في حديثها، لكن كلماتها كانت دائماً ما يقطعها ذلك السعال الذي لا يلين – لقد كانت مدخنة شرهة. صفية أنطون سعادة بضحكاتها الصاخبة الممزوجة بأحاديثها المفعمة بالحيوية، أليسارأنطون سعادة وعيناها اللتان تتحدثان أكثر بكثير مما ينطق به لسانها ثم كانت أمي بالطبع. ابنة المرعبي والحديدي، وعُرف خالها بشهادته وثباته في مقاومة الاستعمار الفرنسي في عكار، وبنى الجامع قرب القصر أو القلعة, أول امرأة دخلت القومية العربية عندما كانت وعودها صادقة. أمي التي أخذتنا إلى الكنائس لنضيء الشموع باحترام وإلى المساجد، وعلّمتنا الدين وأن الأديان هي محبة ورحمة وأخلاق وثورتها على البنى الاجتماعية العرجاء التي تحرم البشر أصالتهم
قوميات في أعماق أرواحهن، إيمانهن بهوية عربية موحدة كان حصناً لا يتزعزع. ما زلت أراهن، جالسات في صالوننا، يحاولن دفع العالم نحو الأفضل، بتعليق ساخر مدروس التوقيت. كان المزاح حاداً كالشفرة، وعميقاً بشكل لا يصدق، ومشبعاً تماماً بتلك الروح الرحبانية الفريدة – ذلك المزيج الخاص من الفكاهة اللاذعة، التشاؤم المتعب، والأمل الكامن بأيام أفضل. يا له من عالم كان ذلك الذي صاغهن بهذا العمق، ومن خلالهن، صاغنا.

أتذكر بوضوح لحظة في إحدى محاضرات الفلسفة السياسية بالجامعة، حين تحدث أستاذنا الدكتور وضاح نصرالذي لم يكن مجرد أستاذ بالنسبة لي؛ بل كان مرشدي الذي صاغ كياني بعمق أكبر من أي شخص آخر بعد والديّ, عن رفيقه الشاعر خليل حاوي وشاهدت كيف تحولت عينا الدكتور نصر الزرقاوان المعتادتان إلى الحُمرة تحت غشاء ماء مالح يحول ان يغسل
الألم، وكيف استسلم صوته لتلك الغصة في حلقه، ثم صمت بعد أن روى لنا قصة الشرفة، والحرب، وحاوي نفسه. مثل هذه القصص، مثل هؤلاء الأشخاص – لا يمرون ويُنسون ببساطة. بل يحفرون أنفسهم عميقاً في روحك. إنهم يبقون. إلى الأبد. كما زياد.
الآن، يبدو ذلك العالم بعيداً. أمي، ديزي، و أدما، صفية و أليسار باتوا جميعاً مع حاوي والآن زياد في السماء، تذكرة مؤثرة بمسيرة الزمن التي لا تتوقف والتحولات العميقة في واقعنا. وبينما يستمر “الفيلم الأمريكي الطويل” في رتابته، تصبح هذه الأسماء همسات خافتة تصل عميقاً في النفس.. عبقريتهم، إرثهم، جوهر ما مثلّوه، غالباً ما يسقط على آذان صمتها الثرثرة المتواصلة للحاض.

فهل نحن، إذن، آخر أمناء ذاكرتهم، الجيل الأخير الذي أدرك حقاً التأثير العميق لذكاء حاوي الحاد، و قلب الرحباني الشاعري، و أوتار خليفة الثورية؟ هل مهمتنا أن نوقظ أولئك الذين يعمهون في سباتهم، أن نذكّرهم بالثراء الذي ورثوه، وبالجمال الذي يخاطرون بفقده في ضباب الهتك الحديث أم نترك كل هذا الثراء لأنفسنا؟
ربما. ربما في التذكر، في الاعتزاز، في الانخراط الفاعل مع الإرث العميق لهؤلاء العمالقة والروح التي أشعلوها في أشخاص مثل ماما، واصدقاؤها وأختي، وأنا، يمكننا أخيراً ألإستمرار حتى إتمام فيلم الحياة الغريب والعودة إلى الموسيقى التصويرية الأصيلة، المفعمة بالروح. إنها مهمة شاقة، لكنها أصبحت أكثر إلحاحاً بسبب الصمت المطبق لأولئك الضائعين في سباته
زياد: أتمن لك نزلة السرور الأبدي بعد بروفات عديدة للموت.
المرحوم كان مهضوم و كان يحن على المحروم.. بالآخر.. و بلأول.. بلا ولا شي أما
بالنسبة لبكرة شو.. هلأ لح تعرف بس ما فيك تقلنا.. تاكسي… خذني ع آخر الدني… البلد ما بقا فيها شي إلي… إنو مشوار هالدني مشوار..
مش ضروري النّهايات تكون
سعيدة عطول ،خيّي أنت منّك عايش بفيلم.. أد ما طول الفيلم.. بيجي وقت و بخلص. هيك هي الحياة وبدنا نطول بالنا..
ديما بالآخر في آخر و في وقت فراق.. و بعد الفراق.. لقاء..
خاصّ – إلا
Share this content:








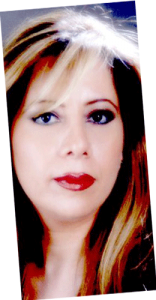




تعليق واحد