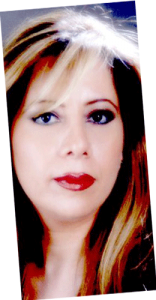وباء الأصوليّة بين منظّري الرأسماليّة.. ولحى “داعش”!
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|

إعلامي وكاتب لبناني
إلى أيّ مدى يا ترى يمكن أن تذهب خلاصة الأبحاث التي توصّلت إليها أستاذة علم الأعصاب في جامعة أوكسفورد كاثلين تايلور بشأن ارتباط الأصوليّة الدينيّة بالأمراض العقليّة؟
هذا السؤال الملحّ الذي خرج إلى دائرة الضوء على هامش محاضرة ألقتها تايلور في مهرجان “هاي للثقافة والفنون” في مقاطعة ويلز البريطانيّة عام 2013، ما زالت أصداؤه تتردّد بحدّة لغاية يومنا الراهن، ولا بدّ للإجابات العلميّة عليه من أن تشكّل في القريب العاجل بوصلة اهتداء صوب الأرضيّة التي يمكن على أساسها إيجاد وسائل العلاج لمثل هذا “المرض المزمن” الذي يواصل التفشّي حتّى في المجتمعات التي كانت حتّى الأمس القريب مستعصية عليه، وبالشكل الذي غالبًا ما يؤدّي إلى الفتك بضحايا ضحاياه الأبرياء أكثر من ضحاياه المرضى أنفسهم، أي بمن لا ذنب لهم سوى أنّهم يعيشون في تلك المجتمعات، وخصوصًا في هذه البقعة المترامية الأطراف من العالم التي ما زالت تُسمّى، بقدرة قادر، وطنًا عربيًّا، والتي تقرع فيها الأصوليّة الدينيّة نواقيس الخطر، يومًا بعد يوم، وبشكل لم يعد يهدّد ماضيها وحاضرها وحسب، وإنّما مستقبلها ومستقبل الحضارة الإنسانيّة فيها على حدّ سواء.
بحسب تايلور، ينبغي على العلم إيجاد وسائل العلاج للتطرّف الدينيّ الذي “يدخل في باب الاضطراب العقليّ، وليس عملًا جنائيًّا”، بمعنى أنّ الأصوليّ يُفترض أن يصنّف كمريض يحتاج إلى علاج وليس كمجرم. فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام المسؤول والملتزم والمتّزن على هذا الصعيد، سيّما وأنّ الخطاب التأجيجيّ الذي كانت بعض المؤسّسات الإعلاميّة العربيّة وغير العربيّة قد تبنّته، وخصوصًا في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، هو الذي ساهم في الأساس في نموّ ظاهرة الأصوليّة الدينيّة وحوّلها إلى وباء، سواء عن دراية وسابق عزم وتصميم أم عن جهل وقصر نظر، علمًا أنّ الخلاصة التي توصّلت إليها الباحثة البريطانيّة في مجال دراستها لم تنحصر في إطار الأصولية الإسلاميّة وحسب، بل اشتملت على عيّنات أخرى كتلك التي اعتبرت أنّ دفاع الجهاديّ الإسلاميّ عن عقيدته بذلك الأسلوب المتطرّف الذي يوصله إلى الجريمة، قد لا يختلف عن سعي المؤمنين بالعقيدة الرأسماليّة الذين قاموا، على سبيل المثال، بقتل الآلاف إبان حكم الرئيس الأميركيّ ريتشارد نيكسون إرضاءًا لبارانويا العداء للشيوعيّة، وهو الاعتبار الذي دفعها إلى التساؤل بتهكّم “عمّا إذا كانت أصوليّة أسامة بن لادن أقلّ وطأة من أصوليّة منظّري الرأسماليّة الذين أمطروا لاوس وكمبوديا وكوريا الشماليّة بالقنابل”؟
صحيح أنّ تقرير كاثلين تايلور يبرز عددًا من النقاط، وعلى رأسها اللاحياد العلميّ فيما يتعلّق بالقضايا الأخلاقيّة والإنسانيّة، مؤكدًا أنّ التطوّر التقنيّ في مجال البحوث التي تسعى إلى تصنيف العقول البشريّة إنّما يخفي وراءه نزوعًا ضمنيًّا إلى الإقصاء، وخصوصًا على صعيد تبرئة الذات ووضع عقول الآخرين في “مصحّة للأمراض العقليّة”. غير أنّ التقرير من جهة أخرى، يبرز ضمنيًّا الميل المتزايد إلى رفض جميع أشكال التطرّف الفكريّ والعقائديّ حتّى على مستوى الممارسات الشخصيّة اليوميّة المرتبطة بثقافة العنف. فمنذ زمان “يهوديت الأرملة” التي تقول بعض الأسفار إنّها تمكّنت من التسلّل إلى خارج أسوار مدينة القدس لتنجح في إغراء الجنرال أليفانا قائد جيوش “ملك الأرض” نبوخذ نصر أثناء الحصار الذي فرضه على المدينة تمهيدًا لاقتحامها، قبل أن تقوم بقطع رأسه على سريره في تلك الخطوة الجريئة التي أربكت ضبّاطه وحالت دون سقوط القدس في قبضتهم، مرورًا بزمن “إيجال عمير” الذي قال إنّ الله أمره بتنفيذ عملية اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيليّ إسحاق رابين في تل أبيب، ووصولًا إلى عقل كلّ حاخام يسمح لنفسه بالتجوّل علنًا في شوارع الأراضي المحتلّة من فلسطين التاريخيّة مزوَّدًا برشّاشه الحربيّ من نوع “إم – 16″، بدا أنّ نزعة التطرّف في اليهوديّة، سواء في تجليّاتها الدينيّة الخالصة أم الصهيونيّة المُستحدَثة، كانت ترتكز دائمًا إمّا على دافع الدفاع عن النفس والأرض والمكتسبات، أو على دافع الرغبة في تحقيق مكتسبات جديدة، حتّى أنّ التغطية على ذلك التطرّف، ومحاولات تبريره، غالبًا ما كانت تتمّ على خلفيّة استحضار تلك الشواهد التاريخيّة التي يظهر فيها الفرد اليهوديّ على أساس أنّه ضحيّة وليس جلّادًا، على غرار ما فعله مثلًا الحاخام إميل فاكنهايم في كتابه “الله في التاريخ” عندما قال: “لقد كان بوسع إيمانويل كانط، على رصانته ورجوح عقله، أن يذهب جادًّا إلى حدّ اعتبار أنّ الحرب تخدم الأغراض الإلهيّة. أمّا بعد هيروشيما، فقد بات الناس ينظرون إلى الحروب كافّة باعتبارها في أفضل الحالات شرًّا لا بدّ منه. وقد كان بوسع عالم اللاهوت توما الأكويني، على ورعه وقداسته، أن يؤكّد جادًّا أنّ الطغاة يخدمون الأغراض الإلهيّة، إذ بدونهم تنتفي فرص الاستشهاد. أمّا بعد أوشفيتز، فإنّ أيّ إنسان يذكر هذه الحجّة يُتّهمُ بالكفر. فبعد تلك الأحداث الرهيبة التي وقعت في قلب العالم التكنولوجيّ المستنير الحديث، هل لا يزال في الإمكان أن نؤمن بإله يمثّل التقدّم الضروريّ أكثر ممّا نؤمن بإله تتجلّى قدرته في صورة عناية إلهيّة تراقب مسيرة الكون”؟
وإذا كانت الأديان السماويّة التي تلت اليهوديّة قد تمكّنت، إلى حدّ ما، من تهذيب نزعة التطرّف على خلفيّة تعاليم السيّد المسيح عليه السلام وقوله مثلًا: “سامحهم يا أبتاه لأنّهم لا يدركون ما يفعلون”، فإنّ استغلال الدين في السياسة، هو الذي أدّى إلى قيام من تحدّثت عنهم كاثلين تايلور في تقريرها من منظّري الرأسماليّة بإمطار لاوس وكمبوديا وكوريا الشماليّة بالقنابل. والأخطر من ذلك، فإنّ التطرّف في أوساط أولئك المنظّرين، كان قد ضرب أطنابه بشكل خطير لم يسبق له مثيل في التاريخ الإنسانيّ الحديث، وذلك عندما قام الرئيس الأميركيّ السابق جورج بوش بالإفصاح علنًا لنظيره الفرنسيّ جاك شيراك بأنّه ذهب إلى العراق عام 2003 لكي يحارب “بأجوج ومأجوج” هناك، استعدادًا لمعركة الهرمجدون (الجبل المقدّس) الحاسمة.
في مقابل ذلك، وللإنصاف، لا بدّ من الإشارة أيضًا إلى أنّ التاريخ الإسلاميّ لم يُظهر أنّ الفتوحات كانت تتمّ بباقات الورود وحبّات الأرز وماء الزهر، سيّما وأنّ نزعة القتال غالبًا ما كانت تتجلّى بوضوح في ميادين الحرب، على خلفيّة قوله تعالى في سورة البقرة: “وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلّا على الظالمين”، علمًا أنّ القرآن الكريم، ومن ضمنه هذه السورة وغيرها، لا يمكن أن يبرّر لبعض “الفئات الضالّة” (على حدّ تعبير العاهل السعوديّ الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز) مثل الجهاديّين والسلفيّين والتكفيريّين وغيرهم، دفع الأمّة الإسلاميّة بأكملها إلى الدرك الذي وصلت إليه، بفعل ممارساتها المتطرّفة الشنيعة، بدءًا من تدمير تماثيل بوذا على غرار ما فعله عناصر حركة طالبان في أفغانستان، مرورًا باحتجاز الأطفال وإرهابهم داخل مدارسهم على غرار ما فعله الانفصاليّون الشيشان في مدينة بيسلان الروسيّة، ووصولًا إلى انتزاع أكباد البشر وأكلها أمام عدسات التصوير على غرار ما فعله عناصر “داعش” في سوريا. وهذه النماذج إن دلّت على شيء، فهي تدّل على أنّ وتيرة نزعة التطرّف تواصل ارتفاعها على مقياس الخطورة، نظرًا لأنّ تجليّات حالاتها الإجراميّة لم تعد مقتصرة على استهداف الحجر وحسب، بل وصلت إلى حدّ استهداف البشر، وبأبشع الصور، الأمر ساهم في إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام، ولدرجة لم نعد نسمع فيها غير النادر جدًّا عن تورّط رعايا الأديان الأخرى بهذه الخطيئة الدمويّة المرعبة. ولولا قيام النرويجيّ أندريس بريفيك (32 عامًا) بقتل أكثر من ثمانين شخصًا من أنصار الحزب الحاكم بالرصاص خلال هجومه الشهير على مخيّمهم الصيفيّ في جزيرة أوتويا السياحيّة قرب أوسلو عام 2011، لكانت مقولة “إنّ الإرهاب لا دين له” قد أسقطت من حسابات المتابعين لهذا الملفّ البالغ الخطورة والتعقيد.
قد يكون من المفيد هنا استحضار ما ذكره صاحب نظريّة “نهاية التاريخ وخاتم البشر” المفكّر الأميركيّ فرانسيس فوكوياما عن أنّ إحدى أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة بحقّ نُظُمها القيميّة، تمثّلت في أنّها اكتفت بالعمل على تحقيق مصالحها السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة من خلال تحالفاتها مع عدد من الدول الغنيّة في الشرق الأوسط، دون أن تبذل أيّ جهد يذكر على صعيد إقناع قادة تلك الدول بالقيام بتوزيع عادل لثرواتهم الوطنيّة على شعوبهم، الأمر الذي أفسح في المجال أمام بروز ظاهرة التطرّف والإرهاب في تلك المجتمعات التي راحت تتحوّل تدريجيًّا إلى بيئة حاضنة لتفريخ الإرهابيّين وتصديرهم إلى الخارج. وممّا لا شكّ فيه أنّ موضوع التفاوت الطبقيّ، يشكّل بالإضافة إلى موضوعيْ الدين والجنس، زوايا ما يُعرف بـ “الثالوث المحرّم”، نسبةً إلى الكتاب الشهير الذي أصدره بو علي ياسين تحت نفس العنوان في سبعينيّات القرن الماضي، والذي اعتبر فيه أنّ الخطوط الحمراء التي وضعها القائمون على رسالات رسل الله على الأرض للحيلولة دون التطرّق للدين، حتّى خارج نطاق الإلحاد، وللجنس، حتّى خارج نطاق الإباحيّة، وللتفاوت الطبقيّ، حتّى خارج نطاق الشيوعيّة، أدّت في نهاية المطاف إلى خلق مجتمعات منغلقة على نفسها، يعيش فيها بشر يعانون في الأصل من مشكلات لا حصر لها على صعيد التفاهم مع طموحاتهم ورغباتهم الشخصيّة، وهي المشكلات التي تسبّبت لهم بـ “اضطرابات عقليّة”، على حدّ تعبير الباحثة كاثلين تايلور، ودفعتهم إلى تبنّي نهج الأصوليّة والسير على طريق الإرهاب.
بيد أنّ النقطة الأهمّ التي يُفترض استحضارها في سياق الحديث عن ظاهرة الأصوليّة والإرهاب، هي تلك التي تتعلّق بدور الإعلام الواعي في التعاطي مع هذا المدّ الأصوليّ الإسلاميّ الهائل، وهي النقطة التي غالبًا ما يلجأ الإعلاميّون والباحثون إلى الهرب منها، على طريقة النعامة التي تضع رأسها بين ساقيها، كلّما كانت تخرج إلى دائرة الضوء.
وإذا كان اثنان لا يختلفان على أنّ قناة الجزيرة في قطر هي التي افتتحت موسم الترويج للفكر الأصوليّ، منذ أيّام تلك المقابلة القديمة التي أجراها الزميل جمال اسماعيل مع أسامة بن لادن في أواخر تسعينيّات القرن الماضي، والتي استخدمها مدير الأخبار السابق في الجزيرة الزميل صلاح نجم في برنامجه الشهير واليتيم “رجل ضدّ دولة.. ودولة ضدّ رجل”، فإنّ عمليّات الترويج لذلك الفكر، ظلّت مستمرّة حتّى بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ولدرجة دفعت الكثيرين إلى حدّ الاعتقاد بأنّ إغراق وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة بأخبار عن ثقافات الأصوليّين وتحرّكاتهم، كان بمثابة ضرورة ملحّة للدعاية الرسميّة الأميركيّة التي كانت تسعى في اتجاه توفير المبرّرات الأخلاقيّة لاستمرار خططها الاستراتيجيّة في مجال “الحرب على الإرهاب”، علمًا أنّ تلك الدعاية، سرعان ما تحوّلت إلى سلاح ذي حدّين كليهما مسلّطان على رقبة الولايات المتحدة، ويتمثلان في اتّساع رقعة انتشار الفكر الأصوليّ بشكل لم يسبق له مثيل. وما الخلايا الصاحية والنائمة التي تتوزّع فوق خريطة العالم من الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا وشرقها ووسطها، ومن أفغانستان وباكستان إلى ماليزيا وإندونيسيا وميانمار، ومن القوقاز وتركيا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبيّ، إلّا أبشع دليل على ذلك.
ولعلّ الحديث عن خطايا قناة الجزيرة الفضائيّة وغيرها من الفضائيّات العربيّة في هذا المجال له أوّل وليس له آخر، وخصوصًا من جهة توفير منصّة انطلاق لفكر أقلّ ما يمكن أن يقال عن أصحابه هو أنّهم يمثّلون مجرّد بؤر معميّة القلب والعقل والروح والبصيرة، تمثّل بدورها الجهل بحدّ ذاته، وتأتينا في وقت تشهد فيه الحياة الإنسانيّة تطوّرات مذهلة بدءًا من ثقافة المرحاض وصولًا إلى ثقافة استكشاف الفضاء.
وإذا كان التفكير بـ “عقليّة المؤامرة” يغري كثيرًا بطرح مئات التساؤلات عمّا إذا كانت تلك الفضائيّات قد فعلت فعلتها في المجتمعات العربيّة والإسلاميّة مع سبق الإصرار على نوايا مبيّتة أم لا، وخصوصًا في ظلّ تحوّل مهنة الإعلام من رسالة إلى تجارة، فإنّ ما يُفترض وضعه على رأس سلّم الأولويّات في الوقت الحاليّ، هو كيفيّة العمل على وضع حدّ لهذا الانتحار الإنسانيّ المجنون. وهذه مسألة لا يمكن لمقال أن يعالجها، سيّما وأنّ المدى الذي قد يصل إليه توصيف التطرّف سيكون واسعًا، وخصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ الباحثة البريطانيّة كاثلين تايلور، لم تتحدّث عن الحالات الواضحة فقط، مثل “الأصوليّة الإسلاميّة أو بعض الجماعات الأخرى الأكثر تطرّفًا”. على حدّ تعبيرها، بل تحدّثت أيضًا عن أمور حياتيّة مختلفة مثل “المعتقد الذي يقول إنّ معاقبة الأطفال بالضرب أمر لا بأس به”، وهي أمور متّصلة فيما بينها بالعنف الذي لا يبدو في أيّ حالة من الأحوال خيارًا شخصيًّا، أو نتيجة إرادة حرّة تامّة، بقدر ما يبدو مرضًا متّصلًا بالاضطراب العقليّ، وينبغي علينا البدء بإيجاد علاج شافٍ للأشخاص المصابين به، تفاديًا لسفك المزيد من دماء لا يفترض أن تكون رخيصة إلى هذا الحدّ.
جمال دملج
إعلامي وكاتب لبناني
play youtube
xnxx
xhamster
xvideos
porn
hentai
porn
xxx
sex việt
henti
free brazzer
youpor
brazzer
xvideos
play youtube
play youtube
Brazzer
xhamster
xvideos
xvideos
porn
porn
xnxx
xxx
sex việt
Phim sex
mp3 download
Nike Compression Sleeve
American porn
Download Mp3
henti
Holiday Lyrics Madonna
play youtube,
play youtube,
xvideos,
Brazzer,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xvideos,
porn,
sex việt,
mp3 download,
Find Mac Address Of Mac,
porn,
Aruba Tripadvisor,
phim xxx,
Mp3 Download,
Share this content: